تنتمي موريتانيا إلى منطقة الساحل الأكثر تضررا من دورات الجفاف المتكررة منذ عام 1968. وجاء هذا الضغط المناخي ليضاف إلى الثورة الاجتماعية التي يعاني منها سكانها ـ تلك الثورة التي تتميز على وجه الخصوص بشكل خاص بهجرة قوية لسكان الريفي إلى المدن – مما سبب تدهورا ملحوظا للبيئة وتغيرا كبير جدا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة، الشيء الذي عمق التفاوت بين الناس.
ويعني الأمر جميع القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. واستجابة للكوارث المتكررة الناتجة عن هذه الوضعية، تخصص الحكومة الموريتانية بانتظام جزءا من ميزانيتها لبرامج المساعدة السكان الضعفاء. هذا هو الحال بالنسبة للبرنامج أمل الذي حصل في عام 2012 على غلاف مالي أولي قدرها 42 مليار أوقية و تمويل 12 دائري بمبلغ مليار أوقية سنويا، أي ما يساوي تمويلا تراكميا بلغ حوالي 78 مليار أوقية للفترة 2012 ـ 2015. ويتبع هذا البرنامج الاستعجالي برنامجا سابقا من نفس النوع، يدعى "التضامن"، كلف، في عام 2011، تسعة مليارات أوقية. ولكن هل تحل هذه التدخلات المشاكل الأساسية؟ بدءا بالتدهور المستمر، إن لم يكن المتسارع، للبيئة؟
يستنكر عدد من الخبراء "الإنهاء المستمر لحماية بعض الغابات المحمية"، "لاستغلالها في الزراعة المروية، وتتعرض موارد الأخشاب النادرة للاستغلال المفرط، وتنزع أشجار الأحزمة الخضراء وتحول إلى أحياء سكنية جديدة، وتقام الصناعات الملوثة، دون أي احترام للمعايير وحتى حظر استيراد السيارات التي تجاوز عمرها ثماني سنوات [الإجراء الملموس الوحيد فقط تعتزم للمساهمة المقررة المحددة وطنيا في موريتانيا، ملاحظة من هيئة التحرير] قد أدى إلى نتائج عكسية لأن السائق الموريتاني يسير بسيارته القديمة- إلى أبعد من التلوث الذي قد تسببه سيارة مستوردة تجاوز عمرها ثماني سنوات". وهكذا نستطيع تمييز فئتين رئيسيتين من المشاكل.
أولا: الاستغلال المفرط للموارد المتجددة - إزالة الغابات، الضغط المفرط على الأراضي الصالحة للزراعة، والرعي الجائر والصيد الجائر، مما يسبب على وجه الخصوص، التصحر وتناقص التنوع البيولوجي، وهي ذاتها مشاكل ذات طبيعة مزدوجة: التسيير، من جهة، والحماية، من جهة أخرى، الأمر الذي يثير مسألة أكثر شمولية هي تقاسم الموارد بين الإنسان والطبيعة. ثانيا: تراكم النفايات، وهي حالة عولمة تحت مصطلح "أشكال التلوث"، تلك النفايات التي تغير أو تشوه أو تدمر وظائف النظم البيئية، محليا وعالميا على حد السواء.
لا نمو اقتصادي مستدام دون بيئة صحية؟
قبل المشاركون في الدورة حول القضايا البيئية في المؤتمر الاقتصادي الأفريق في 29 تشرين أكتوبر 2010 الافتراض الأساسي بأن النمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية، وهو وسيط المحاربة الوحيد، حسب رأيهم، ضد الفقر، ومع ذلك، فهو يشكل مفارق. لقد أثبتت التجربة في كثير من البلدان أن النمو الاقتصادي غالبا ما يؤدي إلى استخدام تعسفي للموارد والتلوث، والفقر المتزايد في نهاية المطاف. وهكذا تبدو الحماية والتسيير المستدام للبيئة متطلبات أساسية للنمو بالنسبة للعديد من المتخصصين.
ويعارض آخرون هذه الرؤية للنمو المتوازن، بنموذج، معاكس تماما، هو النمو المتسارع ، مما يسمح بالتدهور البيئي الأولي، قبل استخدام دخل ذلك النمو من أجل تسيير مناسب للبيئة. لكننا رأينا، خاصة مع مأساة بحر آرال، الذي تم تجفيفه تقريبا للأغراض المسعورة للزراعة الصناعية، حيث تثقل العواقب المترتبة على هذا الاندفاع المتهور كاهل أضعف السكان، وخاصة صغار المزارعين الذين تعتمد إنتاجيتهم بشكل كبير على صحة النظم البيئية. فقد تأثرت كثيرا، على سبيل المثال، بالتغيرات المناخية. وكلما انخفضت هذه الإنتاجية، كلما حملت الضرورة على الممارسات البيئية السلبية، وفي نهاية المطاف، يتعرض المزارعون أنفسهم وأسرهم والمجتمع ككل، لتزايد التوترات الاجتماعية: ليس النموذج الحالي قابلا للبقاء على المدى الطويل، أو حتى على المدى المتوسط. وكلما ارتفعت نسبة الفقراء في بلد ما، كلما أثبتت هذه الحقيقة صحتها بشكل قاطع.
سياسية بيئية رجاجة
يبدو أن السلطات الموريتانية قد وعت على أهمية التسيير، المناسب والمشترك للمحتوى ـ ثروة الموارد الطبيعية للبلاد - والوعاء - بيئتها - سواء لسكانها أو لتنمية اقتصادها. غير أن الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه ترتطم بنقص المعلومات والتحليل بسبب تعقيد الظواهر البيئية، وكثرة عدد الفاعلين المعنيين وأهمية الرهانات المطروحة.
تم تعريف السياسة البيئية لموريتانيا في الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخطة عملها الوظيفية: برنامج العمل الوطني للبيئة. إن هذه الأدوات المصادق عليها في عام 2006، تستهدف، في أفق عام 2015، وتماشيا مع الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر، دمجا أفضل للبيئة ولمفهوم التنمية المستدامة في السياسات القطاعية. كما وقعت موريتانيا على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة. غير أنه، من حيث الأساس بفعل نفس الأسباب المذكورة أعلاه، فإن تنفيذها، بل أحيانا "مجرد" دمجها في القوانين والنظم الوطنية، يظلان محدودين والتشاور حولهما قليل.
لنبين هذه النقطة.إن النصوص التشريعية للحماية والتسيير المستدام للبيئة والموارد الطبيعية موجودة بالفعل، تتعلق أولا بمدونة البيئة (2000) والمرسوم المعلق بدراسة الأثر البيئي (2004، وروجع عام 2007). ومنذ ذلك الحين تم وضع عدة نظم أخرى لإدماج الانشغالات البيئية في السياسات القطاعية وإشراك السكان على نطاق أوسع (مدونة المياه، المدونة الرعوية، مدونة الغابات، تنظيم العقارات وأملاك الدولة، مدونة المعادن، مدونة الصيد، القانون المتعلق بالتسيير التشاركي للواحات، الخ). ويجري إعداد نصوص أخرى مثل مدونة البيئة البحرية. لكن الإطار التنظيمي لم ينفذ إلا قليلا. إن انعدام الرقابة الفعالة وضعف مواءمة النصوص - وخاصة تلك التي تعالج مع نفس الإشكالية – ونقص التنسيق بين العديد من الفاعلين المعنيين قد حدت من مداها العملي.
المخاوف
في النهاية، يظهر استعراض تنفيذ السياسات القطاعية والبرامج أن السياسات الحكومية قد فضلت التنمية الاقتصادية ولم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف الروابط بين البيئة والفقر. وعلاوة على ذلك، فإن الثنائية بين الأهداف البيئية المعلنة وتلك المنجزة، حقيقية. وتتجلى هذه الوضعية في استمرار طرق استغلال للموارد غير فعالة وغير قابلة للاستمرار. وبإيجاز، فإن النقاش بين النمو المقاس والنمو الجامح يبقى مطروحا أكثر من أي وقت مضى: ففي موريتانيا وغيرها، من المرجح أن لا يميل السكان إلى الانشغال ببيئتهم إلا اعتبارا من مستوى معين من الثروة، بعد تأمين الاحتياجات الأولية والثانوية.
وهنا نواجه منافسة بين استنزاف مواردنا والاكتظاظ السكاني. ولكن عندما يكون هناك عدد من السكان يتجاوزون ما تستطيع الأراضي التي يعيشون فيها تحمله، سيتعرض "الفائض" لخطر كبير في القضاء عليه بطريقة "طبيعية"، من المجاعات، على وجه الخصوص. إن الأراضي المستغلة بشكل مفرط تفقد خصوبتها، في حين تزيد احتياجات الناس - السكن والغذاء والطاقة... - بينما تتراكم أشكال التلوث في الحدائق الكبرى الجديدة للإنتاج والاستهلاك التي هي المدن. هل سنصل، في الوقت المناسب، إلى هذا الحد الأدنى من وعي وضعيتنا، لتجنب الكوارث الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار وبقوة تسيير بيئتنا؟ ومن الآن وفي كل يوم تصبح المسألة موضع الساحة وبشكل حاد على نحو متزايد.
مامادو تيام




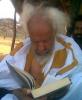




.gif)